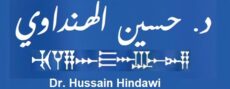–باقر الكرباسي
الزمان أكتوبر ,28 2022
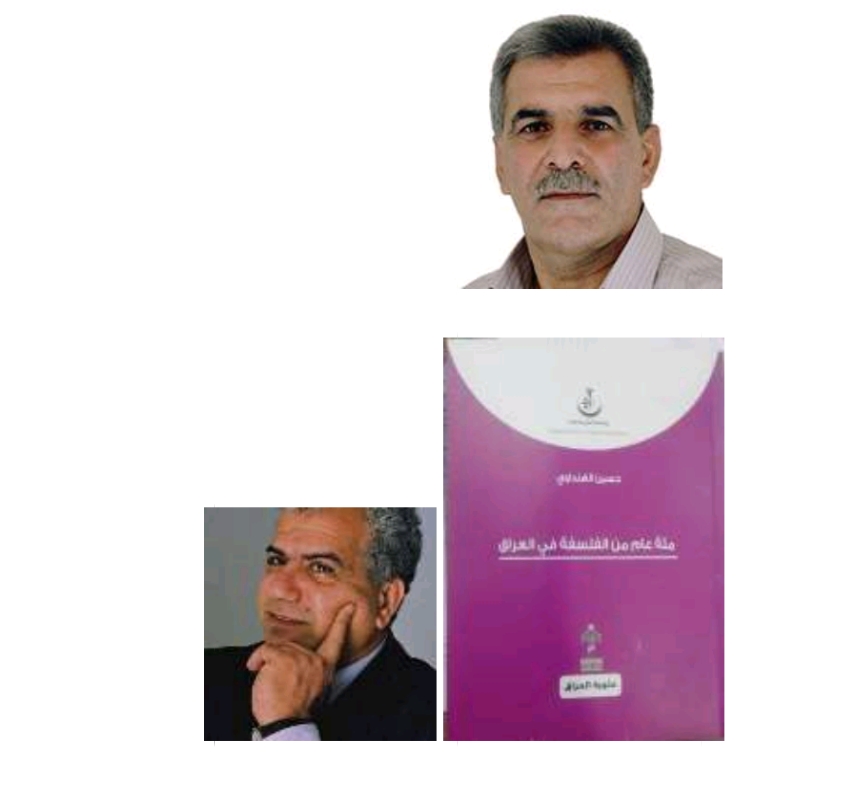
قــــراءة فــــــي كتـــاب مئة عام من الفلسفة في العراق لحسين الهنداوي – باقر الكرباسي
صحيفة الزمان، أكتوبر ,28 2022
يتمتع العراق بعمق تاريخي وغنى حضاري فضلا عن التعدد الثقافي الذي يطبعه منذ آلاف السنين هذه عوامل أهلته للاضطلاع بدوره العلمي المتميز في الحضارة الإسلامية، إذ ظهرت فيه الفرق الكلامية والفلسفية والمدارس النحوية ومعظم المذاهب الفقهية، وكثير من الأحزاب السياسية وجمهرة من أعلام الفكر الإسلامي في شتى العلوم والآداب والفنون ولا خلاف بين المؤرخين على أن الفلسفة لعبت دوراً مهما في تغيير المجتمعات نحو الأفضل، فالعالم الغربي اليوم يقوم على تراث فلسفة الأنوار فلسفة العقل
والعقلانية التي أسهمت في إزاحة التصورات القروسطية للدين والعالم و الإنسان، نحو تصورات علمية عقلانية، فهل حدث مثل ذلك في الشرق وتحديدا في العراق بوصفه أحد البلدان التي تدرس الفلسفة في جامعاتها وتقيم المهرجانات والمؤتمرات الفلسفية سنوياً؟ إن الفلسفة تنمي العقل النقدي وهو امتيازها التي تتمتع به وتمنحه لقارئها ، وهو الذي يفسر لنا لماذا تتعاطى السلطات الاستبدادية مع درس الفلسفة بحذر بالغ، أي أن السلطة هنا تمارس آليات القمع لكل خطاب لا يتماهى مع توجهاتها الأيديولوجية، لأن الاهتمام بهذا الدرس وإفساح المجال لحرية القول فيه قد يكون سببا في شيوع ما يتعارض مع أيديولوجية هذه الأنظمة والعراق من البلدان التي ينطبق عليها هذا المعنى أحد الباحثين – فالسلطة في العراق وتحديداً – النظام السابق – تظهر باستمرار بشكل مزدوج، فهي من جهة راعية للعلم والمعرفة وهذا هو المعلن ومن جهة أخرى عدوة للعلم والمعرفة وهذا غير المعلن لدرجة أننا يمكننا القول : أن معرفة طبيعة موقف نظام ما من العلم والمعرفة ممكنة إذا ما علمنا كيف يتعاطى مع درس الفلسفة، أيسهم في تنميته أم يقمعه ؟ أيعمل على توجيهه الوجهة التي يريد أم يطلق العنان في كل ما يقول ؟ يقول الدكتور الآلوسي ( رحمه الله ) : (لا حياة لثقافة من دون عقل ولاعقل من دون حرية فكر وتسامح فكري وأن مظهر كل هذا حرية الجدل والنقد الصريح بلا لبس ولا رمز ) يقول أحد الباحثين : ( إن الفلسفة في العراق ليست بذات نصيب قوي في التغيير والتأثير في من يدرسونها ((معظمهم)) ولا في المجتمع ولعل مرد ذلك جملة أسباب منها : النظر إلى الفلسفة بوصفها مجالا يؤدي إلى الإلحاد وهي نظرة مصدرها الفكر الديني المتطرف الذي ورثناه من تراثنا الإسلامي والحاضر بقوة إلى الآن في مجتمعاتنا، بفعل تثقيف رموز هذا التيار للمجتمع و تنبيههم إلى خطر الفلسفة، وكأن هؤلاء نسخة من أئمتهم الغزالي الذي كفر الفلاسفة في كتابه ( تهافت الفلاسفة ) والشهرزوري صاحب الفتوى الشهيرة : ( من تمنطق فقد تزندق ) ، يقول الدكتور هشام صالح : ( إن انتصار الأنوار على الظلمات في العالم العربي الإسلامي كله سوف يستغرق وقتاً طويلاً ) الكتاب الذي أقدمه للقارئ العزيز كتاب يخص الفلسفة عنوانه ( مئة عام من الفلسفة في العراق ) للأستاذ الدكتور حسين الهنداوي ضمن إصدارات ارتأت وزارة الثقافة متمثلة بدار الشؤون الثقافية العامة تقوم بطبعها بمناسبة مرور مئة عام على قيام الدولة العراقية وأطلقت عليها ( مئوية العراق ) الكتاب بغلافه الأنيق وبصفحات الـ 280 صدر سنة 2021 بطبعته الأولى، يكتب الدكتور حسين الهنداوي تقديماً لكتابه المهم هذا قائلا:” الوعي الخاص الذي يحققه أي شعب عن ذاته يتجلى في كل النتاج الفكري الخاص بذلك الشعب في علومه وفنونه وأخلاقه وعقائده وأيضا في منجزه الفلسفي، لكن الدولة هي الإطار اللازم للتعبير العقلاني عن الوعي الذاتي الخاص بذلك الشعب، وهذا يعني أنها تستمد مشروعيتها مما تحققه من خير ورفاه للمجتمع، وما توفره من حقوق مدنية فعلية للأفراد، ومن هنا العلاقة المصيرية بينهما، وكما في كل الدول الحديثة، اقترن نشوء وتطور النشاط الفلسفي العراقي المعاصر بولادة الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 كما لو أن أحدهما ظل ينتظر الآخر قبل مئة سنة كي ينطلق تلك الانطلاقة الرائعة المدهشة بنوعيتها الرفيعة المستوى و تنوع مجالاتها الأصيلة والجوهرية إلى درجة يمكن على ضوئها اعتبار المنجز الفلسفي في العراق الحديث بين الأهم في الدول النامية ) ص5. عراق اليوم ويستمر الدكتور الهنداوي في تقديمه قائلاً : ( وفي عراق اليوم نستطيع التكلم عن الفلسفة كما نتكلم عن الأدب والفن، والفكرة السائدة عنها هي أنها بوصلة وحارس العقل العام، ومن هنا هذا اليقين الضمني المهيمن لدى الغالبية العظمى من العراقيين بأن بلدهم هو مهد الفلسفة وبيتها التاريخي، وفي الواقع لدينا اليوم عدد كبير من الأساتذة والتدريسيين الذين يمتهنون الفلسفة، وبعضهم لا شغل له غيرها، ولدينا كتابات فلسفية متميزة كماً ونوعاً، وحتى تيارات فلسفية رغم محدودية تبلورها ونفوذها وضعف ثقتها بنفسها وإخفاقها في أن تتحول الى مدارس متمايزة، ورغم ضعف الحوار أو انعدامه بين المشتغلين بالفلسفة، وكل هذا الضعف من إرث الفترة البعثية التي كانت مأساوية بالنسبة للفلسفة أيضاً، فيما لم تنجح فترة ما بعد 2003 في معالجة ذلك إلا جزئيا أو ربما ساهمت أحيانا في الضعف في كثير من الأوجه، فبتراجع عقلانية الدولة تتراجع عقلانية الثقافة وبالتالي الحضارة السائدة ( ص 5-6 . يتألف الكتاب من فصول خمسة، يتحدث المؤلف في الفصل الأول عن طلائع التأسيس الفلسفي الجديد فيقول : (بدأ اهتمام العراقيين بالفلسفة عفوياً في العصر الحديث وبعد قرون من التراجع والركود ، وكان ذلك عبر بعض الاحتكاك وحتى الإنخراط في الحياة الثقافية التركية التي كانت قد مرت بحقبة طويلة نسبيا من التقلبات طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أسفرت عن إدخال بعض الإصلاحات المهمة في الحياة السياسية عبر ما سمي بـ (( التنظيمات)) والتي جاءت رضوخاً للضغوط المتزايدة من القوى الإجتماعية والثقافية المطالبة بحياة سياسية حديثة أسوة بالدول الأوروبية ( ص 13 . يبدأ الدكتور الهنداوي بالشاعر جميل صدقي الزهاوي ويتحدث عنه قائلا : (ويمكن اعتبار الشاعر جميل صدقي الزهاوي أول عراقي إهتم بالفلسفة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، أذ اصدر عدة مؤلفات فلسفية جاهر فيها بإيمانه بنظرية التطور، وعمل أستاذاً للفلسفة الإسلامية في دار الفنون بإسطنبول، وله شعر فلسفي معروف في جلال الذات الإلهية والوجود والعدم ومقالات فلسفية منشورة في أهم المجلات العربية قبل قرن كما ظهرت ترجمة لبعضها لا سيما قصيدته (( ثورة في الجحيم )) التي يحاكي فيها قصائد مماثلة كـ (( الكوميديا الإلهية (( لدانتي و (( رسالة الغفران (( لأبي العلاء المصري ) ص15 وعن الزهاوي أيضا استمر الدكتور الهنداوي قائلا : ) ويرى رفائيل بطي في حديثه عن كتاب الجاذبية وتعليلها للزهاوي أن الزهاوي كان أول مفكر عربي يهجر التقليد فقد (( حاول حل غوامض العلم الطبيعي معتمدا على عقله وحسه إذ شغف بالعلوم الطبيعية في شبابه فشرع يطالع ما تكتبه المجلات العالمية في هذا الباب وفي مقدمتها (( المقتطف (( مطالعة الباحث المنقب الذي يريد إدراك أسرار الوجود رغما أنّ جل علماء عصر الغربيون والشرقيون لم يوافقوه على آرائه تلك ) ص17.
والزهاوي نظم الشعر بالعربية والفارسية منذ صغره فأجاد فيه، تميز منهج الزهاوي الفلسفي بالاستناد إلى علوم الطبيعة و الظواهر، وخصوصا نسبية اينشتاين ومنهجه
أحد الباحثين الاجتماعي في التحرر واحترام المرأة وتقدير دورها في بناء الوطن، كما تميز شعره بالواقعية ورقة المشاعر ونبل الآراء وجرأة القول والتحريض على التحرر من قيود الدين والتقاليد والمفاهيم العتيقة وتبني الفكر الاشتراكي ، وقال فيه طه حسين : لم يكن الزهاوي شاعر العربية فحسب، ولا شاعر العراق، بل شاعر مصر وغيرها من الأقطار, لقد كان شاعر العقل و معري هذا العصر، ولكنه المعري الذي اتصل بأوروبا وتسلح بالعلم، وينتقل الدكتور الهنداوي إلى شخصية أخرى يراها قد اهتمت بالفلسفة أيضا هو حسين الرحال فتحدث عنه قائلا : ( بموازاة الزهاوي برزت في الساحة الفكرية العراقية في حقبة عشرينيات المئوية الماضية شخصيات اهتمت بالفلسفة من خلال المدخل الأيديولوجي، وأشهرهم الكاتب حسين الرحال، الذي لعب دورا مهما و مبكرا ورائدا في نشر الفكر الماركسي لأول مرة في العراق خلال الأعوام الأولى من عمر الدولة العراقية الجديدة عبر ترجمة بعض النصوص عن المادية التاريخية و تنوير نخبة من الشباب المثقف بمبادئها بالأفكار الإشتراكية وفق منظور واقعي يناسب روح العصر و التطور الحاصل في العالم ) ص22-23 الأولى خلال دراسته في ألمانيا بين 1916 1918 حيث إطلع جيدا على الفكر الماركسي والحركة الإشتراكية الأوروبية وشاهد بنفسه انتفاضة عمال برلين أواخر عام 1918 بقيادة (( عصابة الماركسيين الألمان المعروفة بعصابة سبارتاكوس ، فتفاعل مع الأفكار الإشتراكية التي بشرت بها الثورة الألمانية الوليدة ( ص 23-24 ويكمل الهنداوي حديثه عن الرجال قائلا : ( والمرحلة الثانية بعد عودته إلى العراق إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى فقد عمق من معرفته بالفكر الماركسي عبر ما وصله من كتب باللغة الفرنسية من بينها كتاب ( رأس المال ) لكارل ماركس و ( الإستعمار أعلى مراحل الرأسمالية ) و ( الدولة والثورة ( لفلاديمير لينين، كما إطلع على أفكار الفيلسوف الإيطالي نيكولاي ميكافيلي صاحب كتاب ( الأمير ) وغيرها ) ص 24 وفي فقرة أخرى من حديثه عن الرحال يقول : ( بداهة لم يكن حسين الرحال مفكراً فلسفياً بل لم يهتم بالفلسفة بذاتها ولا لذاتها في اهتمامه المبكر والمثير بنشر بعض الفلسفة الماركسية بين أوساط مثقفي بلدة بيد أن محاولته الرائدة تلك تؤكد بلا ريب أن الفكر الفلسفي في بتياراته العالمية بدأ يطرح نفسه كضرورة بذاتها في العراق وهذا ما تعتقده السرعة اللافتة في انتشار الوعي الفلسفي في العراق خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبموازاة التقدم الكبير والطموح الذي حققه الحركة الفكرية
العراقية خلال تلك الفترة اللاحقة على قيام الدولة العراقية الحديثة ( ص 25, و الشخصية الثالثة من ضمن طلائع التأسيس الفلسفي الجديد هو نهاد التكرلى يبدأ الدكتور الهنداوي حديثه قائلا : ( لكن المفاجأة كانت ظاهرة الإنجذاب المتزايد إلى الفكر الوجودي الذي ظل مجهولاً في العراق حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويبدو أن عمق الشعور الذهني بالضياع وفقدان الحرية والقلق من عدمية الوجود الذاتي وعجز الأيديولوجية السائدة في التأثير أو الإحتواء كانت إنجذاب فئة من المثقفين العراقيين إلى الفكر الوجودي في تلك الفترة حيث وبدا موقفين فكريا أخر أو رؤية جديدة للعالم قادتهم إلى رغبة جامحة في الإمفتاح على آفاق الأخرى، وهذا يفسر استغراق نهاد التكرلي مثلا في (( اعتناق )) الفلسفة الوجودية السارترية والسعي إلى التعمق بها ومن ثم إلى نقل أفكارها للغير مستفيداً من مزايا ذات مترفه فضلا عن معرفة مسبقة باللغة الفرنسية تسمح بذاتها بهجة حقيقية أو متخيلة ( ص 26، ويضيف الدكتور المؤلف وهو يتحدث عن التكرلي قائلا : ( فالمناخ العام لتلك الفترة كان مناخاً ملائما لتعميق الشعور الإنساني بالحضارة ومن مطلقات فكرية معاصرة لذا لم يكن عبثا أن يسود الشعور بالانتماء إلى الفكر الإنساني عبر الفلسفة الوجودية وبالشعور الاجتماعي عبر الفلسفة المادية إلى الحد الذي يتحقق بشكل رؤية (جديدة) ص29, أما الفصل الثاني فقد كان عنوانه ( أول قسم أكاديمي للفلسفة ) ، يتحدث الدكتور الهنداوي عن تأسيس كلية الآداب وقسم الفلسفة فيها : ( منذ انطلاق أولى الدعوات لتأسيس كلية للآداب في عام 1936، وتأسيس قسم للفلسفة حديث حاضر في المشاريع التي كانت تقدم ومنها مشروع طرح في 1942 يقترح تحويل دار المعلمين العالية إلى الكليتين واحدة للآداب وأخرى للعلوم وقد تحقق ذلك عندما نجحت الجهود بفتح كلية الآداب والعلوم في تشرين الأول 1949 التي تقرر أن تتكون من ثلاثة
أقسام أساسي اللغة العربية وآدابها و الاجتماعيات التاريخ والجغرافية و الفلسفة) ص39, ويستمر الحديث عن قسم الفلسفة وتأسيسه واصفاً المرحلة الأكثر خصاً بين 1960 و 1975 مقسماً المسيرة الحديثة لدراسة الفلسفة أكاديمياً في العراق على أربع مراحل هي : ( المرحلة التأسيسية بين 1949 و 1959 المقترنة بإدارة غير عراقية وبالتالي متعثره للقسم، تليها المرحلة الثانية المقترنة بوجود الرواد الأهم في تاريخ النشاط الفلسفي العراقي الحديث ولكل منهم تخصصه و دوره، وهم إلى جانب محسن مهدي في فلسفة التاريخ، ياسين خليل في منطق الرياضيات، وحسام الألوسي في فلسفة الكلام ومصطفى كامل الشيبي في فلسفة التصوف، ومدني صالح في فلسفة الجمال، وكريم متي في الفلسفة الغربية وصالح الشماع في فلسفة اللغة وغيرهم وهذه المرحلة تتموضع إجمالاً بين 1960 و 1979 ، وقبلها الفترة العارفية، ثم المرحلة الدكتاتورية والمكارثية والحروب الحمقاء، والتي امتدت بين 1979 و 2003، وشهدت مآسي حروب عديدة، وهناك أخيراً مرحلة ما بعد الدكتاتورية في 2003 وانعكاس ذلك على الحياة الأكاديمية، وهي فترة اقترنت بتصدع الدولة ومؤسساتها وبتراجع الهوية الوطنية أمام الهويات الفرعية من جهة إلا أنا، قترنت أيضا وبشكل أهم بالنسبة لنا بانطلاقة جديدة وقويه للنشاط الفلسفي في العراق بفضل انكسار حاجز الخوف والإنفتاح اللامشروط على الآخر و الاستفادة من تقنيات التواصل الثقافي والكوني وما توفره من حريات ويسر في الوصول إلى المعلومة من جهة أخرى ( ص 40-41، وبعد شرح مفصل حول نشاط قسم الفلسفة في مراحله الأربع يذكر المؤلف أسماء الأساتذة الذي مارسوا رئاسة القسم والتدريس لمواد الفلسفة المتنوعة . وتحت عنوان ( آفاق نهضة فلسفية واعدة ) يتحدث الهنداوي عن الدرس الفلسفي في العراق بعد الانتفاضة الشعبية الواسعة التي شهدها العراق سنة 1991 وبالرغم من فشلها فيقول : ( بموازاة ذلك وبفضل جهود وإصرار نخبة من الأساتذة والخريجين والطلاب الوطنيين، تمكن الدرس الفلسفي في العراق من تحقيق بعض النجاح التدريجي، تمثل من جهة بتطوير المناهج الدراسية الفلسفية وبفتح أقسام جامعية تخصصية أخرى للفلسفة في عدد من الجامعات العراقية كالجامعة المستنصرية والبصرة والموصل والكوفة والسليمانية وصلاح الدين أربيل وواسط وكربلاء فضلاً عن بيت الحكمة ببغداد بينما استمر قسم الفلسفة في جامعة بغداد بتقوية مكانته الآتية من أسبقية التأسيس ، ودوره السباق في تزويد أقسام الفلسفة الجديدة في المحافظات بالكادر التدريسي من حملة الشهادات العليا ( ص 67 . وجاء الفصل الثالث تحت عنوان ( عطاء فلسفي متجدد ) يقول في بدايته : ( خلال مائة عام من عمر الدولة العراقية الحديثة، عرف تاريخ الثقافة الفلسفية العراقية المعاصرة عدداً مهماً من أساتذة وكتاب الفلسفة الأكفاء الذين كانت لهم مساهمات أكاديمية أو فكرية متميزة كما كانت لهم المبادرة والفضل معاً في تفعيل وتأصيل وإثراء الجهد الفلسفي العراقي خلال القرن الماضي ومنحه مكانة مرموقة على المستويين العراقي والعربي. وينقسم هؤلاء الأساتذة إلى جيلين مختلفين وهما جيل الأكاديميين الرواد أو المؤسسين من جهة و جيل أو أجيال مابعد الرواد من جهة أخرى وهؤلاء ما يزال بعضهم في ضخم نشاطهم بعد ولذلك لن نتوقف عندهم إلا عند الضرورة ( ص 77. تدريس الفلسفة
وفي الفصل الثالث نفسه يتحدث الدكتور الهنداوي عن الذين شغلتهم الفلسفة درساً وتدريساً في العراق ومنذ تأسيس قسم الفلسفة في جامعة بغداد، فيبدأ بالرواد وأولهم الدكتور محسن مهدي ومن ثم الدكتور حسام الآلوسي والدكتور كامل مصطفى الشيبي والدكتور ياسين خليل والدكتور جعفر آل ياسين والأستاذ مدني صالح والدكتور محمد جواد الموسوي والدكتور صالح الشماع والدكتور كريم متى والدكتور عبد الرزاق مسلم ماجد، فيتحدث عن حياة ومنجز كل واحد منهم بتفصيل مكثف يستطيع القارئ أن يكون فكرة عنهم ، ويعطي إلى الذين كتبوا في الفلسفة وهم غير مختصين بها إسم ( المساهمون ( فيذكر الدكتور علي الوردي عالم الاجتماع المعروف، والدكتور عبد العزيز البسام وهو من رواد علم النفس والتربية في العالم العربي، والدكتور نوري جعفر الذي تتلمذ على يد ( جون ديوي ) ومختص في فلسفة التربية والأستاذ عبد الفتاح إبراهيم المؤسس الأول لعلم الإجتماع في العراق والعالم العربي، والدكتور فؤاد البعلي المتمرس بعلم الإجتماع، والدكتور عبد العزيز الدوري شيخ المؤرخين العراقيين وكانت له مكانة متميزة في البحث التاريخي والكتابة التاريخية ولم يسهب الدكتور الهنداوي عند وقوفه وحديثه عنهم أيضاً : حياتهم بايجاز ومن ثم إنجازاتهم، وينتقل إلى عنوان آخر هو أساتذة (متميزون) ويبدأ بالدكتور عرفان عبد الحميد والدكتور ناجي التكريتي والدكتور نمير العاني والدكتور حازم طالب مشتاق والدكتور عبد الأمير الأعسم، ويصفهم الدكتور الهنداوي بأنهم متميزون لتدريسهم المميز في قسم الفلسفة وما أنجزوه من مؤلفات فلسفية يشار لها بالبنان.
وما زال الدكتور في الفصل الثالث إذ يتحدث تحت رقم 4 عن الفقهاء والأدباء والمؤرخين الذين اهتموا بالفلسفة وكتبوا فيها فيذكر السيد محمد باقر الصدر المفكر الاسلامي اولهم والاستاذ هادي العلوي الكاتب الجامع بين الفلسفة والتراث ومن ثم يصل الى الشيخ محمد رضا المظفر المجدد والمصلح المعروف والدكتور عبد الجبار الرفاعي صاحب التجديد في الفكر الديني والدكتور صالح مهدي الهاشم صاحب الرسالة العلمية المعروفة ) بواكير الفكر الفلسفي في بغداد ) والدكتور ميثم الجنابي أستاذ العلوم الفلسفية في الجامعة الروسية وجامعة موسكو الحكومية، ولم يخرج عن منهجه الدكتور الهنداوي فتحدث عن كل واحد منهم حديثا مكثفا مفيدا وفي الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث وتحته عنوان ( جيل بعد جيل ( يقول الدكتور الهنداوي (يشهد المشهد الفلسفي العراقي الراهن نهضة كبيرة تعبر عن نفسها في ثلاثة مجالات أساسية هي أولا: الزيادة اللافتة في عدد حاملي شهادات وبعضهم من أرقى جامعات العالم حيث تشير تقديراتنا الى وجود مئتين وخمسين متخرجاً عراقياً يحمل شهاده الدكتوراه في الفلسفة مع تخصصات تغطي الفترات كافة القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة وجميع مجالات البحث في فلسفات الدين والعلم والسياسة والجمال والتاريخ ونظرية المعرفة وما قبل الفلسفة وثانيا : الزيادة الكبيرة في عدد عدد أقسام الفلسفة أو دروسها في الجامعات والمعاهد التي تكاد تغطي كافة مناطق العراق بلا استثناء الأمير الذي أضاف بشكل كبير عدد طلاب مادة الفلسفة والمتخصصين فيها بمختلف انحاء العراق ) ص 151-152. وهنالك اخيرا تضاعف مبيعات الكتب الفلسفية لاسيما المترجمة الى اللغة العربية خلال السنوات الاخيره ( ص 152 ، ومن أجل اطلاع القارئ على التنوع في مواضيع الرسائل الجامعية التي قدمت لنيل الشهادات العليا من جامعه بغداد نشر الدكتور الهنداوي جدولا بأسماء الحاصلين على هذه الشهادات مع عناوين رسائلهم أما الفصل الرابع والذي اعطى المؤلفين عنوانا هو ) : قراءات و آراء ) وأرى أنه ما كتبه الدكتور الهنداوي في هذا الفصل هو المفيد جدا من هذا الكتاب فكانت دراسته الأولى عن المفكر الدكتور محسن مهدي ببحث قيم عنوانه ( محسن مهدي وإحياء (( العلم المدني )) ( موضحا فيه آراء هذا المفكر الذي يملك مكانه متميزة في الأوساط الفلسفية العربية والعالمية ويقول المؤلف عن المفكر الدكتور محسن مهدي : (و توج الأستاذ محسن مهدي مسيرته العلمية بتحقيقه لنسخة مجهولة من كتاب الف ليله وليله أثبت فيها أنه كان لا يضم سوى 282 ليله، وأن مستشرقي القرنين 18 و 19 هم الذين غيروا ومددوا العدد لكي يصل الى (( ألف ليله وليله )) ( ص 164 وفي البحث أيضا يتحدث الهنداوي عن التكوين الفلسفي للدكتور محسن مهدي وكذلك عن منجزه الفلسفي ومؤلفاته.
ومن ثم وفي البحث نفسه يعزو الدكتور الهنداوي للدكتور محسن مهدي الكشف عن فلسفة التاريخ عند إبن خلدون عن إطروحته التي قدمها في جامعه شيكاغو سنه 1954 بعنوان ( فلسفه التاريخ عند إبن خلدون) – دراسه في الأساس الفلسفي لعلم الثقافة والتي تعد أول إنجاز متميز له، وأعمق ما صدر من دراسات عن إبن خلدون حتى ذلك الحين بعدها يقول الدكتور الهنداوي وتحت عنوان ( إحياء فلسفة الفارابي السياسية ) : ( وهكذا اغدت إعادة اكتشاف فلسفة أبي نصر الفارابي المعروف ب (( المعلم الثاني (( لاسيما فلسفته السياسيه بمثابه المنجز الكبير التالي الذي حققه محسن مهدي ) ص183, ينتقل المؤلف الى دراسة أخرى أنجزها عن الدكتور حسام الآلوسي
ونسبية الأخلاق قائلا : ( على الصعيد الشخصي ظل العثور على كتابات أستاذي الآلوسي إستثنائيا بعد إضطراري على الهرب من الوطن العراقي الى المنفى بسبب القمع البعثي، كانت هناك بعض المقالات الفلسفية العراقية النادرة تصلنا منشورة في صحف ومجالات عربية بين حين وحين إلا أن كتابا أصدرته دار الطليعة ببيروت عام 1989 بعنوان (التطور والنسبية في الاخلاق )) نكأ فرحي وانتباهي من جديد الى أهمية الكبيرة بين مفكري الفلسفة في العالم العربي في فترة كانت الأنشطة الفلسفية في العراق في طفوت ملموس مقارنة بالحيوية الملحوظة التي كنا نرصدها بيسر خلال النصف الثاني من القرن العشرين في الوسط الفلسفي العربي لاسيما في المغرب (الحبابي، العروي، الجابري, الخطيبي (…) أو في مصر ( زكي نجيب محمود، عبد الرحمن بدوي، زكريا ابراهيم وحسن حنفي … ) أو في لبنان (حسين مروه علي حرب ناصيف نصار …)، وفي سوريا ) صادق جلال العظم، طيب تيزيني، جورج طرابيشي … عانى الفكر الفلسفي في العراق غيابا مدهشا حيث لم نكن نسمع شيئا عنه كما لو انهم غير موجود بعد، ولم يقتصر مصدر الدهشة على غرابة الظاهرة كتلك في ثقافة عرفت ان تكون حيوية في ميادين أخرى برغم كل الصعوبات والحصار والقمع ص197. ويستمر المؤلف في توضيح كتاب الالوسي بقراءة معمقة لكتابه المهم هذا وينتقل الهنداوي الى فارس ثالث في الفلسفة هو (كامل) مصطفى الشيبي وتجديد دراسة التصوف) فيقول : (و(( التصوف الفلسفي)) هو ما رحنا نعمق فكرتنا عنه مع مرور الوقت بفضل أستاذنا الكبير سواء لدى ابي يزيد البسطاسي صاحب مبدأ الفناء أو أبي منصور الحلاج صاحب مبدأ الإتحاد الروحي أو السهر وردي الحلبي صاحب حكمه الإشراق أو إبن الفارض والعديد سواهم ( ص 202201، ومن ثم
يكتب أشهر مؤلفاته بعد أن انتهى الدكتور الهنداوي من دراسته عن الدكتور الشيبي انتقل الى الدكتور عبد الرزاق مسلم ماجد ونظرية المعرفة عند إبن خلدون فيكتب ) ولعل دراسة نشرتها له في عام 1968 مجله (المورد) الصادرة عن جامعة البصرة عن نظرية المعرفة عند إبن خلدون تعبر بشكل واف عن منظورات المفكر عبد الرزاق مسلم في مجال الفلسفة الخلدونية وهي منظورات كانت ستأخذ ربما لديه منحى أكثر خصبا وتوسعا وتأثيرا في مصير ذلك المنظور الذي أراد أن يثبت علاقه قوية بين ابن خلدون والفلسفة وأن يجد المقدمة أفكارا تدعم التفسير الماركسي للتاريخ وتكون جذرا لنظرية ماركس حول تطور قوى الانتاج وهو تفسير كان قد أسسه في أوروبا ) ص 207
الشعر العراقي الحديث والفلسفة – بلند الحيدري نموذجا – هو عنوان موضوع يتحدث فيه الدكتور الهنداوي قائلا : ( لم تنقطع الفلسفة عن الحضور في الشعر العراقي الحديث المعاصر وهو ما نجده متجسدا بشكل ساطع وكثيف لدى أبرز شعراء القصيدة العمودية وخاصه لدى جميل صدق الزهاوي وأحمد الصافي النجفي حيث مضمون الفلسفي مباشر وموروث بشكل عام أما لدى شعراء القصيدة الحديثة فيأخذ المضمون الفلسفي في القصيدة أبعاداً اكثر تعقيدا تعكس الإسلوب الجديد في الكتابة المتمحور حول استخدام الرمز أو الأسطورة أو الإيجاء في التعبير من جهة ويبدو متأثراً بشكل جلي في الغالب بالتيارات الفلسفية الشعرية الغربية الحديثة والمعاصرة وخاصة الرومانتكية والماركسية والوجودية والسريالية والصوفية ) ص 222 ، وبعد حديث ممتع عن هذه التيارات وأثرها على الأدباء والكتاب فيقول : ( بلند الحيدري من جانبه إنكب على تثقيف نفسه ثقافة شعرية خاصة، فأخذ يقرأ من بينهم ما كانت تنشره المجلات والصحف اللبنانية، وبخاصة مجلة الأديب بين عامي 1940 و 1947 متأملاً رمزية سعيد عقل ورومانسية الياس أبي شبكة، كما فتن بأشعار عمر أبي ريشة ومحمود حسن اسماعيل، لكنه أكد في أكثر من مناسبة تأثره المبكر بالتيار الوجودي ذاك وأنه راح يقرأ بشكل دائم لجان بول سارتر والبير كاموكما اطلع على نصوص نسبت الى هيغل أو كيركفارد أو هايدغر أو شونبهور أو سواهم كانت تنشرها هنا أوهناك مجلات أو صحف وصلت الى يديه ) ص226 227 ، وأريد هنا أن أضيف شيئاً مهماً الى ماكتبه الدكتور الهنداوي في قضية حضور الفلسفة في الشعر العراقي الحديث والمعاصر وهو أن الأستاذ الشاعر فارس حرام كتب رسالة علمية عنوانها ( الحضور الفلسفي في الشعر العراقي المعاصر – شعر سركون بولص أنموذجاً ) في سنة 2015، إذ أكد فيها أن الفلسفة كانت حاضرة بقوة في شعر سركون بولص. ويستمر الدكتور الهنداوي بالحديث عن نهاد التكرلي وعن الفن التشكيلي وحضوره في بلورة هذه التجربة عبر نزار سليم لكنه سيتعزز باللقاء مع جواد سليم خاصة الذي أثر في بلند الحيدري تأثيراً واضحاً حسب قوله.
أما الفصل الاخير من الكتاب فقد خصصه الدكتور الهنداوي بـ نماذج خاصة من كتابات الرواد
وكان اختياره موفقاً : نحو معرفة جديدة للدكتور جعفر آل ياسين 1977، والمستشرقون واللا تاريخ لمدني صالح 1974، ومهمة الفلسفة والمناطقة الوضعيون لنجم الدين بزركان 1957 و مفهوم التراث العلمي العربي للدكتور ياسين خليل 1989
كتاب الدكتور حسين الهنداوي كتاب مهم في مرحلة معرفية مهمة أيضا كي نقرأ ما كتبه الكبار في الفلسفة التي انقطعنا عنها بعض الشيء للظروف التي مرت بالعراق تهنئة خاصة للدكتور الهنداوي على كتابه الماتع هذا.