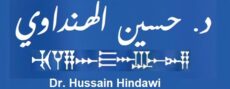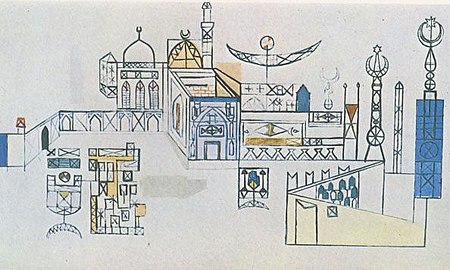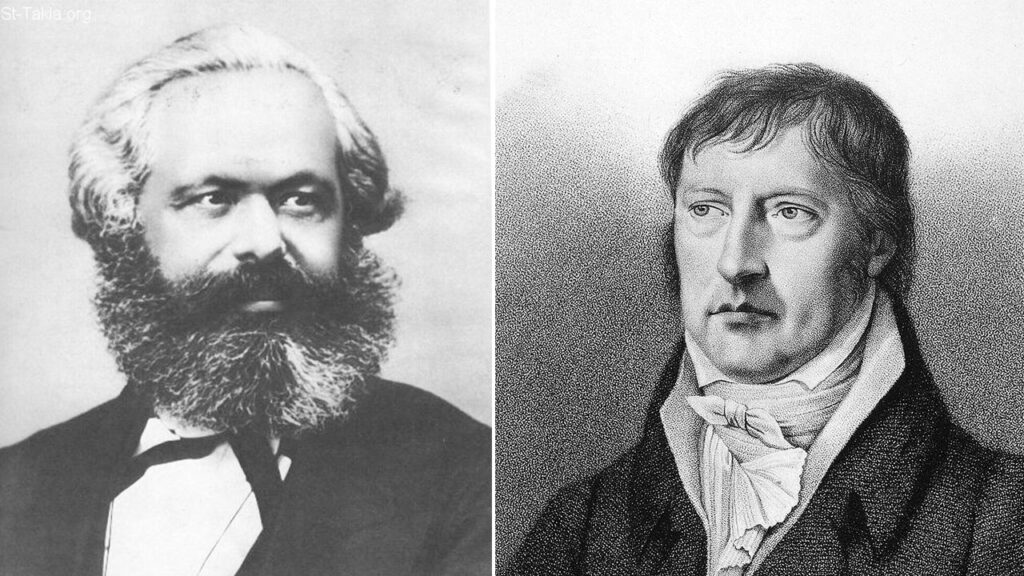صحيفة المدى- 4/4/2021
لماذا لم تعرف بلداننا عصر تنوير لحد الآن؟ وهل ستعرفه في القريب المنظور؟ وكيف يمكن تحقيق شروط نجاحه كما حققها الأوروبيون خلال القرنين الأخيرين وكذلك فعل إثرهم الاميركيون واليابانيون والصينيون وحتى الأتراك ونجحوا هم أيضاً لو نسبياً هنا أو هناك..
هذه الأسئلة تؤرقني أكثر فأكثر كلما تلاشت إمكانية الجواب ومن قبل الجميع في الواقع. والحال لا نهضة ولا تحرر بل لا تحضر بدون حركة تنوير جريئة وحرة لا تقلد أحداً ولا تنشغل بسفاسف الأمور بل تتجه مباشرة الى تأصيل نفسها لأبعد ما تستطيع في تاريخنا وتراثنا وفكرنا التنويري الأصيل الذي يجد خلاصته في كتاب “فَصلُ المقال فيما بين الحِكمة والشَّريعة من الاتصال” للفيلسوف الخالد ابن رشد.
تقع فترة ما يعرف بـ «عصر التنوير» في حدود القرن الثامن عشر الميلادي، وبشكل أدق في الفترة ما بين وفاة الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت (1596 – 1650)، الذي يعد أول من وظّف مفردة “التنوير” للدلالة على قدرة العقل في إداء دور النور الطبيعي في الكشف عن الحقائق الفلسفية، وبين قيام “الثورة الفرنسية” في 1789، والتي يصطلح على اعتبارها «بنت» فلسفة عصر التنوير.
وتعد فرنسا والمانيا وبشكل أقل انكلترا، بمثابة الوطن المشترك لولادة وازدهار تلك الحركة الفلسفية ونطاقها الأكثر خصباً وحيوية على صعيد ثراء العطاء النظري كما على صعيد التأثيرات الفعلية. لكن افكارها وتأثيراتها وجدت اصداء لها في كل القارة الأوروبية من الجزر البريطانية الى روسيا القيصرية، بل امتدت لاحقاً الى العالم كله بما فيه الشرق وخاصة الشرق الأوسط.
وتمثلت «فلسفة التنوير» جوهرياً بتيار فكري جديد ذي نزعة عقلية ونقدية كونية إنسانية، قادته الى تبنّيه الجريء لموضوعة أن الفكر ينبغي أن يكون حراً مهماً كانت النتائج. من هنا ولدت حتمية تصادمه العنيف أحياناً مع سلطة الكنيسة في مجال المعرفة والأخلاق، ومع أنظمة الحكم المطلق في مجال السياسة والحقوق. فلقد شُغفت حركة التنوير بمغامرة السعي العقلي لدحض أو رفض أي منظومة دوغمائية وأيّ نظام قِيَم موروث مهما كانت الشرعية أو المصداقية التي يدعيها والشكل التاريخي الذي يعتمده، واعتبار هذا الرفض بمثابة السبيل الوحيد لتحرير الإنسان من الأحكام الجاهزة والقيم الخاطئة والعبودية الفكرية والسياسية بشكل عام.
لكن حركة التنوير لم تطمح أبداً أن تكون مجرد حركة هدّامة أو متمردة أو مشاكسة، إنما أرادت أيضاً، بل خصوصاً، أن تقيم على أنقاض ما تهدمه، صرحاً جديداً من المفاهيم والقيم الواقعية والسامية، معتقدة أن الإنسان بانعتاقه من أسر ومحدودية الأفكار الجامدة الموروثة، سينطلق نحو امتلاك وعي إنساني وكوني حقاً.
فعبر إحلالها العقل محل النقل، والفهم محل الفرض، والحرية والتسامح محل العبودية والتعصب، مثّلت «فلسفة التنوير» ثورة كبرى ضد مزاعم الحق المقدس، الإلهي أو الوضعي، في تجاوز سيادة العقل أو في تكبيل نزوعه نحو الحرية والكونية والحقيقة. ثورة لولا انتصارها لما أمكن لأوروبا أن تنتقل من عهد مسلمات العصور الوسطى الراكدة الى عهدها كـ «عالم حديث».
فبفضل الروحية الجديدة التي أشاعتها «فلسفة التنوير»، بدأ المفكر الأوروبي يشعر بالتحرر من الموروث اللاهوتي- السياسي- المعرفي المتعلق بالحضارات الأخرى لاسيما الشرقية منها. ففي القرن الثامن عشر، صار الاهتمام بالشرق والدفاع عن حقه بنيل مكانة مركزية لائقة في التاريخ الكوني، يقترنان دائماً بسجال نقدي عنيف ضد المعتقدات المسيحية وتبعياتها وانعكاساتها على القيم الأخلاقية والمفاهيم السياسية والآداب والفنون والعلوم، الى الحد الذي أعلن فيه مفكرون غربيون عديدون أصرارهم الشديد على رفض مصداقية مجمل الأحداث التاريخية المؤسسة على نصوص “الكتاب المقدس”، واستبدالها بأخرى مؤسسة على المؤلفات العربية أو المدونات المصرية أو الحوليات الصينية أو جميعها معاً. كما عمل آخرون على إثبات إيجابيات استقلال الأخلاق عن العقيدة الدينية المسيحية واليهودية عبر التذكير ببساطة ونقاء الأخلاق الكونفوشيوسية أو بطبيعة وبراءة قيم البادية العربية مثلاً.
كما غدت الاستعانة بالشرق والعودة الى عطاءاته الحضارية المختلفة، وسيلة مثلى لدى مفكري التنوير لدحض المفهوم الاكليروسي الذي كان يبدو مطلق الصدق والقائل بأن المسيحية هي الدين الحقيقي الوحيد. وكذلك لتفنيد مزاعم الأنظمة الملكية الأوروبية الاستبدادية، بوربونية أو غيرها، بأنها أنظمة الحكم الأسمى.
من جهة أخرى كانت فكرة المساواة المطلقة بين البشر من الأفكار الأساسية التي قامت عليها وبشرت بها «فلسفة التنوير»، داعمة إياها بمذهب ما سمّي بـ«الدين الطبيعي» الذي اعتقد أن هناك ديناً أصلياً انبثقت منه كافة الديانات المعروفة في تاريخ الإنسان بما فيها الديانات الكبرى كاليهودية والمسيحية والاسلام. وعليه فاليهود والمسيحيون والمسلمون وكل أتباع الديانات الأخرى.. هم جميعاً ليسوا إلا اتباع ديانات تفرعت أو انشقت عن ذلك الدين الطبيعي الأول.
هذه هي بكلمة الأسس والظروف التي استندت لها «فلسفة التنوير» في معركتها للإطاحة بواحدة من أهم المسلّمات المقدسة في الفكر المسيحي التقليدي، ونقصد موقفه من الأديان الأخرى. لكن الإسلام خاصة كان وبامتيازٍ الدين الأجنبي الذي تمحورت حوله تلك المعركة أكثر من غيره. والاسلام لم يكن ديناً مجهولاً أو غريباً بالنسبة لمفكري التنوير، إنما كان، الى جانب اليهودية، معروفاً بشكل جيد نسبياً على صعيدي عقائده الأساسية وتاريخه العام.
وهناك سبب آخر لعب دوراً مهماً في دفع مفكري التنوير الى اختيار الإسلام أداة في صراعهم ضد طبقة الاكليروس، وهو متانة وعراقة التراث الفكري- اللاهوتي الذي دأبت الأخيرة على ترويجه ضد الشرق والشرق الإسلامي خاصة، ويجد جذورها دائماً، وبشكل مثير، في إرث لاهوتي عتيق وقاتم، قائم في الجوهر على افتراضات ذاتية مؤسسة عن سبق إصرار بدورها على بعض المعلومات الانتقائية دائماً والشوهاء غالباً. وخلاصة ذلك الإرث، إن الذاتية المسيحية الغربية تصورت الشرق وخاصة الشرق الإسلامي باعتباره “الغرب مقلوباً”، وفي كل مميزاته وخصائصه ونواقصه.
ولقد استقرت هذه الصورة في الوعي المسيحي كأمر واقع منذ أن اكتشف أمراء الكنيسة فشلهم في مواصلة الحملات الصليبية وتيقنهم من عجز الكنيسة الأبدي عن تحقيق سيطرةً عالميةً مستديمة أو نفوذاً أحادياً مطلقاً على الصعيد الجغرافي أو التاريخي أو الثقافي.
لقد كان العرض الذي تقدم ضرورياً جداً برأينا، في التمهيد لفهم ماهية الدور الاستثنائي الذي لعبه فلاسفة التنوير في إغناء المنظور الغربي حول الإسلام. فهذه الحركة التي استحوذ عليها هاجس تصفية الحساب بالكامل مع مفاهيم القرون الوسطى، كان لا مفر أمامها من الاصطدام بالتركة الفكرية الثقيلة المتجسدة في التصورات المسيحية حول الإسلام والتي امتلكت، لوحدها ربما، تاريخاً معقداً من التطور يوازي الى حد مثير تاريخ الحضارة المسيحية الوسيطة ذاتها منذ مطلعه حتى لحظته الختامية. ويبدو أشبه بترسانة من الحجج والمواقف، الدينية والعقلية وحتى اللاعقلية، جاهز للتوظيف على الفور ليس ضد الإسلام وحده، بل وضد غيره ايضاً من الأديان الأجنبية أو من التيارات والفرق والنخب «المنحرفة» أو «المتمردة» أو «المخالفة» لكن المسيحية دائماً. فأثناء الحروب الدينية الأوروبية، كانت الكاثوليكية والبروتستانتية تتراشقان الإدانة في ما بينهما وكل يستخدم ذات الحجج التي كان الفكر المسيحي قد بلورها ضد الإسلام في ما مضى. والأكثر من ذلك كان هناك، بين زعماء وأساقفة الاكليروس الكاثوليكي، من ذهب الى حد اتهام البروتستانتية المسيحية بأنها مجرد فرقة إسلامية، ولعل النموذج الصارخ في هذا المجال قيام البندكتي الانجليزي وليم رينولدز، استاذ اللاهوت في جامعة رانس، بتأليف كتاب في العام 1600 تألف من 1106 صفحات لإثبات انتساب البروتستانتية الى “الديانة المحمدية”!
حتى بعض فلاسفة التنوير وقادة الثورة الفرنسية لم يسلموا من الاتهام بالتأثر بالإسلام. حيث بدا منطقياً تشدّدهم في رفض تلك التركة الفكرية الضخمة التي وجدوا أنفسهم يصطدمون بها في خضم صراعهم مع الاكليروس لا سيما وأنها تتضارب مع معرفتهم المتنامية حول الإسلام.
ومهما يكن الأمر، لقد احدثت حركة التنوير ومثلت انقلاباً كبيراً على عالم من الافكار حول الاسلام كان صلباً ومهماً في كل الغرب قبلئذ. وجاءت ترجمة المؤلفات الفلسفية لابن سينا وابن رشد والغزالي الى اللاتينية في هذه الفترة لتعمق من هذا الفهم الجديد للإسلام الذي يجد أصوله لدى روجيه بيكون الذي كان ربما أول من طرح ضرورة الحوار والتعامل الفكري مع المسلمين إذا أرادت الكنيسة لنفسها أن تجذبهم الى إيمانها. كما أنه أول مفكر مسيحي اقترح اعتبار الاسلام ضمن نفس الدائرة التوحيدية مع اليهودية والمسيحية رغم إيمانه العميق والمعلن بان المسيحية هي الديانة الإلهية الحقيقية الوحيدة.
لكن رامون لول (1316-1232) تجاوزه في ذلك لتصريحه باعتقاده أن الاسلام أكثر الأديان جميعاً قرباً الى المسيحية. وهذا ما يفسر اندفاعه الشديد والمبكر لتعلم اللغة العربية التي، إضافة الى تدريسه إياها في الأديرة والمعاهد، كتب بها العديد من مؤلفاته الفلسفية واللاهوتية.
وبالقدر الذي راحت أوروبا المسيحية تترك مكانها تدريجياً لأوروبا الحديثة لم يعد الإسلام يبدو كعدو أساسي لا سيما منذ مطلع القرن السابع عشر. هذا الاتجاه الذي أسسه رامون لول وتبعه عليه غيوم بوستل وآخرون في ما بعد، هو البداية الأولى لعصر التنوير في ما يتعلق بالنزعة الإنسانية الشاملة لديها وأيضاً بالموقف من الإسلام. فقد نشر الفرنسي بولانفييه كتاباً مهماً بعنوان «حياة محمد» تضمن أفكاراً جديدة تماماً في هذا الاتجاه، إذ اعتبر ان نبي الإسلام هو «رجل دولة لا مثيل له ومشرع أرقى من كل ما انتجته بلاد الإغريق القديمة». وقبله كان المفكر الفرنسي بيير بيل قد دافع بجرأة في «القاموس الفلسفي النقدي» عن نقاء الاخلاق الاسلامية وكذلك عن نبي الاسلام الذي وصفه بالمبشر المخلص الحماس الساعي الى انقاذ الانسانية.
ومن جانبه شدّد الفيلسوف الألماني الكبير لايبنتز. في مقدمة كتابه «العدالة الربانية» )1710( على أن نبي الإسلام لم يحد أبداً عن المبادئ الاساسية لـ«الدين الطبيعي»، وإن للمسلمين الفضل العظيم في جذب عدد كبير من الشعوب الوثنية الى الإيمان بوحدانية الله التي كانت الكنيسة قد فشلت في ذلك من قبل، أما لسنغ، فقد أدان بقوة التشويهات التي ألحقتها الكنيسة الرومانية بالإسلام ونبيه معتبراً اياها «نسيجاً من الأباطيل».
تلك كانت باختصار العناصر الاساسية للأرضية العامة التي انطلق منها فلاسفة التنوير في تناولهم لموضوع الإسلام، أما جوهر إضافة كل منهم في هذا الشأن فيمكن اختصاره كما يلي:
مونتسكيو نقل الموقف اللاهوتي من الإسلام الى موقف ايديولوجي كاسراً بذلك قدسية كل التراث المسيحي حوله.
فولتير دعا الى اعتبار الاسلام ديناً مماثلاً ومساوياً للمسيحية في كل المجالات وبالتالي لا يقل أهمية عنها في صناعة الحضارة البشرية ونشر الوحدانية الإلهية العقلانية ونادى بالبحث عن الحقيقة التاريخية لذاتها في تقييم الإسلام ورفض الحكم المسبق وخاصة اللاهوتي على الإسلام وهو حكم ينطلق من اعتبار كل الديانات الأخرى غير المسيحية مجرد ديانات زائفة وهرطقة.
روسو وجد أن جوهر الإسلام العميق يتمثل في كونه ديناً هدفه إشاعة العدالة الأسمى بين البشر رافضاً هكذا اقصار ذلك الهدف على المسيحية التي يرى أن قيادتها ابتعدت عن هذا الهدف وتحولت الى شريك لأنظمة الحكم المطلق في استعباد الناس.
دوارد جيبون، المؤرخ البريطاني ومؤسس علم التاريخ الحديث في الغرب، طالب بدفن الموروث اللاهوتي المسيحي وأحكامه الاعتباطية حول الإسلام الذي اعتبره حامل ثقافة جديدة وعقلية منفتحة بشكل أرقى من عقلية الكنيسة الجامدة وثقافتها.
هيردر دعا الى اعتراف علني بدين كبير للاسلام في إيقاظ أوروبا وإخراجها من قرون الظلام مشيداً بالفضل الكبير للمفكرين المسلمين على الحضارة الغربية الحديثة.
غوته لم يجد فرقاً يذكر بين الإيمانين المسيحي والإسلامي بل ذهب الى حد القول في إحدى رسائله الى أن الإسلام “أقرب الأديان” إليه، وكتب مسرحية في تمجيد شخصية نبي الإسلام كما أصدر مؤلفاً كبيراً بعنوان “الديوان الشرقي الغربي” كرسه للكشف عن الجماليات الروحية في نصوص عدد من الشعراء المسلمين.
هيغل جعل الإسلام في فلسفته للتاريخ جزءاً من العالم الجرماني أي المسيحي إلا أن موقع الاسلام في المعادلة الديالكتيكية الخاصة التي وضعها لذلك العالم يكون كنقض للكاثوليكية أي أرقى منها روحياً فيما جعل اللوثرية كنقض النقيض أي كنقض للاسلام وبالتالي أعلى منه في سيرورة التطور الكوني للوعي معبراً عبر ذلك التقسيم عن نزعة ذاتية لوثرية تتلبس ثياب الفلسفة لدى هذا الفيلسوف، نزعة وجدناها حاضرة لديه بشكل أو آخر حيال كل الأديان الأخرى، ولا يغير من الأمر أنه وضع الإسلام أعلى من الكاثوليكية بل إنها فكرة لوثرية أصلاً.
لقد ركزنا على عدد محدّد من هؤلاء المفكرين دون غيرهم وذلك لأهميتهم الخاصة كممثلين لحركة التنوير من جهة ولامتلاكهم منظوراً متميزاً خاصاً بهم الى هذا الحد أو ذاك عن الإسلام,
د. حسين الهنداوي