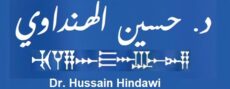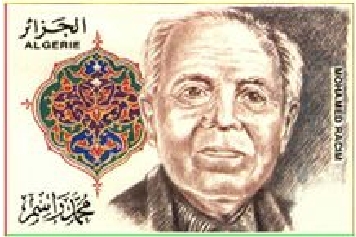د. حسين الهنداوي.
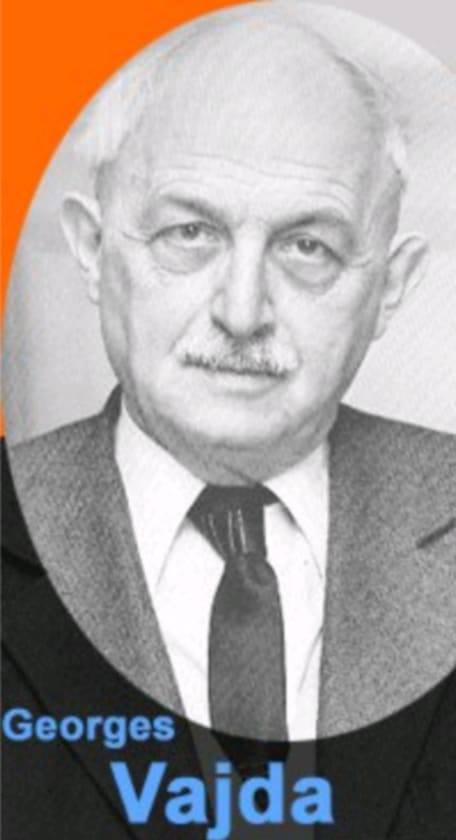
.العصر الذهبي للفلسفة اليهودية كان في بغداد أيام كانت هذه والثقافة صنوان
هذا الإستنتاج سبقني إليه المؤرخ اليهودي الفرنسي، الهنغاري المولد، جورج فايدا Vajda Georges ـ (1981-1908) في كتابه “حكماء ومفكرون يهود في بغداد وقرطبة”، والصادر في باريس حديثًا. وهو تتويج خاص لحياته في ميدان دراسة الفلسفتين الإسلامية واليهودية وتحقيق مخطوطاتهما والكشف عن العلاقة بينهما. فجورج فايدا هو بحق، ومنذ وفاة صموئيل مونك، أكبر المتخصصين في الغرب في بحث الفلسفة اليهودية التي نشأت في الشرق الإسلامي.
وإذا كان تأليف هذا الكتاب قد إكتمل منذ 1980، فإن وفاة المؤرخ في العام التالي هي التي أدت إلى تأخر ظهوره طويلاً.
فصول الكتاب تضم دراسات تتمحور حول إشتغال المفكرين اليهود بالفلسفة في ظل الحضارة العربية – الإسلامية خلال الفترة بين القرنين التاسع والخامس عشر الميلاديين.
وتتوزع النصوص على مجموعتين أساسيتين. تتناول الستة الأولى مسألة الإشتغال بالفلسفة لدى اليهود قبل الإسلام، فيما تخص الفصول الأخرى تاريخ الفلسفة اليهودية في الشرق الإسلامي منذ طلائع التأسيس الفلسفي في بغداد وحتى سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس.
أما الفصل الأخير فمكرس لدور المترجمين اليهود في نقل نصوص الفلسفة العربية – الإسلامية إلى أوربا حيث يقدم معلومات غير معروفة بشكل منظم لحد الآن.
وغني عن القول هنا أن دور هؤلاء المترجمين، بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر الميلاديين، كان عاملاً مباشراً في ولادة الفلسفة الغربية الحديثة بل الحضارة الغربية عموماً.
لكن لماذا شعر اليهود بالحاجة الى التفلسف؟ لذات الاسباب التي دفعت المسلمين أو المسيحيين أو سواهم للإشتغال بالفلسفة إنما في ظروف خاصة مرتبطة أو منبثقة من خصوصية العقائد اليهودية في ما يخص العلاقة بين الله والانسان إجمالاً وبينه وبين “الشعب المختار” من جهة اخرى.. يجيبنا جورج فايدا.
وهكذا، ولأسباب مختلفة عقائدية وتاريخية لم يجد المفكر اليهودي حتى ظهور المسيحية أي ضرورة للاستعانة بالفلسفة للتماهي مع الحقائق الإلهية التي يقدمها الدين. إلا أن التحدي اللاهوتي المسيحي المنبثق من قلب اليهودية والفشل السياسي اليهودي المتفاقم والحرية الدينية والثقافية التي أتاحتها الإمبراطورية الرومانية لشعوبها أدى إلى إنبثاق تيار متأثر بالفلسفة اليونانية، يقول بضرورة الفلسفة لفهم الدين بل بإمكانية التوفيق بينها وبينه. وذلك التيار الاخير بلغ ذروة مجده مع المفكر اليهودي فيلون الإسكندراني الذي عاش في القرن الميلادي الاول. فهذا رغم بقائه لاهوتياً أكثر منه فيلسوفاً ورغم تأكيده الدائم على أن الدين وليس الفلسفة هو مصدر وأصل الحقيقة المطلقة، فان ما يميزه عن المفكرين اليهود الآخرين هو كونه أول من طرح الحقيقة الدينية اليهودية بصيغة فلسفية وأول من استعمل الطرق العقلية البحتة لإثبات المبادئ اللاهوتية.
لكن إفلاطونية فيلون الملموسة وتأثره الكبير بالثقافة اليونانية التي ينتمي لها، لم تسمح لمنهجه ان يحتل مكانة مرجعية متنفذة في الوسط الثقافي اليهودي الشرقي عموماً. وهذا الوسط بدوره لم يعرف إنجاب مفكرين يواصلون الطريق الذي شقه فيلون. لذا سرعان ما تراجع هذا التيار منتقلاً من الهامشية إلى الغياب التام ابتداءً من القرن الثاني الميلادي حيث لم يعرف تاريخ الفلسفة في الشرق والغرب ظهور أي مفكر فلسفي بين اليهود خلال القرون اللاحقة ولغاية انبثاق الحضارة العربية- الاسلامية.
والبداية الحقيقية لإنكباب المثقف اليهودي على الإهتمام بالفلسفة تتموضع في نهاية القرن التاسع الميلادي وذلك بعد فترة مهمة نسبياً من إنطلاقة الحركة الفلسفية العربية الإسلامية في بغداد. وهذه البداية يتكرس لها الفصل السابع من الكتاب والمعنون بـ”الوسط اليهودي في بغداد”، في حين تغطي الفصول اللاحقة التطور الصعودي لما يسميه المؤلف “بالعصر الذهبي للفلسفة اليهودية” المنتهي بسقوط الدولة الاسلامية في الاندلس. أما محطات ذلك العصر الذهبي الخاص بالفلسفة اليهودية، فتبدأ مع بدء التواجد اليهودي في بلاد ما بين النهرين إلى القرن السادس قبل الميلاد وربما قبله.
فقد تمتعت الطائفة خلال فترة طويلة إستمرت حتى الفتح الاسلامي بعلاقات تعايش سلمي مع الفئات الاخرى في البلاد. وعندما جاء الفتح الاسلامي فإن الدولة الإسلامية تركت للطائفة اليهودية إمكانية مواصلة حياتها التقليدية تلك على صعيد ممارسة التقاليد الدينية والثقافية الموروثة. وعندما جرى تأسيس بغداد كعاصمة للخلافة، انتقلت الطائفة تدريجياً لتتخذ منها هي ايضاً عاصمة لها إدارياً وثقافياً ودينياً.
ذلك الإنتقال سيكون حاسماً في ما يتعلق بالإهتمام بالفلسفة. فبموازاة التطور السريع الذي عرفته الفلسفة الإسلامية وبتأثير سريع منها تكونت في بغداد نخبة ثقافية يهودية نزاعة إلى القطيعة مع التقليد. وهكذا تدريجياً راح التركيز على الدين واللاهوت يترك مكانه للإهتمام بإستقبال الفلسفة والمنطق. وفي اطار هذه النخبة بالذات ظهر الرعيل الاول من المتفلسفين اليهود وفي مقدمتهم داود بن مروان المقامي وسعيد إبن يوسف الفيومي (882-942) المعروف بإسم (سعاديا) والذي يعتبره فايدا أول مفكر فلسفي يهودي شرقي. والفيومي مصري الولادة جاء للدراسة والإستقرار في بغداد. وهناك إبن كمونة وهبة الله أبو البركات وهؤلاء جميعاً كانوا على علاقة متينة بالمتكلمين المسلمين ومتأثرين جداً بهم كما تعكسه مؤلفاتهم المكتوبة باللغة العربية جميعاً والمتضمنة معرفة واسعة بالعقيدة الاسلامية والنزعة المعتزلية المزدهرة في بغداد آنئذٍ.
فالفكر اللاهوتي طاغ في كتابات هذا الرعيل الأول المسمى “القرائون” وهم اشبه بالمتكلمين المسلمين إذ أن موضوعاتهم كانت هي ذات موضوعات المعتزلة كتنزيه الذات الإلهية من المادة ورفض التجسيم والتعددية وتعريف الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات وفكرة الخلق من عدم والعناية الإلهية والعدل وفكرة المعجزات إلا إنهم أقل حرية من المعتزلة في تأويل النص المقدس. أما الفكر الفلسفي المحض فلم يظهر لدى اليهود إلا في القرن العاشر وبتأثير مباشر من إنتقال الفكر الإسلامي من المنهج الكلامي إلى المنهج الفلسفي وتحقيقه إنجازات كبيرة فيه أصلاً (مع الكندي والفارابي خاصة) حيث ظهر أوائل المتفلسفين اليهود وأبرزهم إسحق الإسرائيلي وسلمون إبن غابرول بن غياث وإبراهيم بار وبهيا بن يوسف، ويميزهم جميعاً تتلمذهم وتبنيهم للفلسفة الفارابية التي كانت في ذروة نفوذها. ويرى فايدا أن الفارابي إحتل على الدوام مكانة خاصة لدى المفكرين اليهود. إلا أن إنتقال السيادة في الفكر العربي الإسلامي من الفارابي إلى إبن سينا أدى بدوره إلى ظهور جيل من المفكرين اليهود يتبع مدرسة إبن سينا الفلسفية ويقف في مقدمتهم جودا الليفي وإبراهيم بن عزرا ويوسف القرطبي وخصوصاً الفيلسوف الكبير أبو عمران موسى إبن ميمون المولود في قرطبة والمتوفى في القاهرة. فهذا الفيلسوف اليهودي الذي عاصر إبن رشد، قدم أهم مؤلف فلسفي في تاريخ الفلسفة اليهودية حتى مجيء العصر الحديث وهو “دلالة الحائرين” الذي كتبه باللغة العربية.
نستطيع مما تقدم أن نرى بشكل يسير أن الفترة الذهبية لتاريخ الفلسفية اليهودية والمتموضعة زمانياً بين القرن التاسع والرابع عشر الميلاديين ومكانياً في عواصم الحضارة العربية الاسلامية بغداد وقرطبة، هي نتاج مباشر للتعايش مع المسلمين من جهة والتطور العلمي والفلسفي الذي حققه العرب والمسلمون من جهة اخرى.
كما نلاحظ ان التطور الداخلي لتاريخ الفلسفة اليهودية ذاك مدين بشكل مباشر لتأثير تطور أسبق في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ومراحله الكلامية والفلسفية المتعاقبة. وهذه الاستنتاجات نجدها واضحة بشكل اكيد في الكتاب. لكن فايدا لا يأخذ بنظر الإعتبار أن العديد من الأسماء التي ذكرها (كأبي البركات وابن كمونة وغيرهما) هم مفكرون من أصل يهودي فقط وليسوا يهوداً ما دمنا نعرف بأنهم إعتنقوا الإسلام ودافعوا عنه ضد خصومه حتى من اليهود وهذا ما تشهد عليه مؤلفاتهم ذاتها. وما يلفت الإنتباه بشكل مثير أيضاً هو أن فايدا لا يهتم بالتمييز بين المفكر الفلسفي والمفكر اللاهوتي بشكل جعله يعتبر فلاسفة كثيرين ممن ذكرهم في حين أنهم مجرد لاهوتيين صريحين أحياناً في رفض الفلسفة منطلقين من موقف ديني صارم ضد الفلسفة بشكل عام.
ولنلاحظ أخيراً الميل الغريب لدى فاديا بإنشاء علاقة مباشرة بين المفكرين اليهود في بغداد وقرطبة وبين الفلسفة الإفلاطونية والأرسطية بينما تؤكد المصادر الأصلية بأن هذه العلاقة لم تكن مباشرة قطعاً إنما كانت عبر تبني وتطوير الفلاسفة المسلمين لعدد من مبادئ الفلسفة الإغريقية.